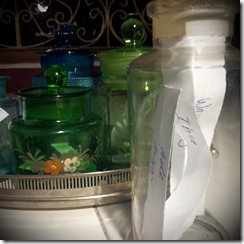الليليين في جلساتهم الدائرية حول النار (المعسل و الأكل) أشبه بالوثنيين الباغان Pagan و أتباع ويكا بدلا من الحنفيين. لأن أتباع الأديان القديمة و بقايا الوثنية الحالية (الهندوسية، و القبائل البدائية في غابات الأمازون و بورنيو)، كده بيسووا: يراقبوا النجوم، يسهروا الليالي، يعيشوا في الظلمات.
بالذات في الشهر اللي يزيد فيها مراسيم الملذات و السهر و مراقبة الفلك و المجرات السماوية، و الصحصحة على النهج الفامبايري/النوكتورنالي/الليلي. و لأن الظلام تضيق الحواس إلى مدى وصول الضوء الاصطناعي (اللمبة و الشمعة و النار)، ليس من الغريب ظاهرة الاهتمام الزائد حول النهايات و الموت و أحداث ما بعد الموت بين الليليين أكثر من الصباحيين.
.
أفكارنا مبنية على مدركات الحواس، من الكلام اللي نسمعها، الأكل اللي نستطعمه، التغريدات اللي نقراها، الصابونات اللي نتشمّمه. بما أن مدى إدراكنا للعالم محدد على مدى الضوء الاصطناعي، يعني الليل تجبر على التركيز حول الذات و ما أدراك ما الذات. بالتالي، أساليب العلم و الفن و اللهو بالنسبة لأبناء الليل من النوع المنحصر حول الذات و الملذات و امتداد لهذه الذاتيات (“نفسي و أهلي و مالي و ديني و حبيبي و بس”).
و لأن الليل طبيعتها كئيبة و حتمية (مين يسهر الليالي غير الزعلان و الوسواس و الحرامي؟) فحرس الليل مائلون للاستهلاكية و الأنانية أكثر من الصباحيين. و العكس صحيح، أن الإنسان الصباحي، مع انشغاله بالإنتاج، طبيعته الاستهلاكية أبطأ و أكثر تأني لأنه مدرك بجميع حواسه قد إيش الأرض واسعة و تتطلب حذر في توزيع المصادر.
الصباحيون مضطرون يوسعوا آفاق نظرهم حيثما تصل ضوء الشمس. للخارج البعيد، للأرض و المطر و النحل و متطلبات الحقل و المحصول و المراعي و الرعيّة بكل ما فيهم من احتياجات صباحية/دايورنالية. مما أدى إلى ميل تركيز دراساتهم الفلسفية حول مشتقات الصباح : الثبات و التتبع الروتيني و الانتظام النسبي (لأن ضوء البزوغ تفرق عن ضوء الضحى و الزوال و العصر و المغيب. أما الليل، من أول لآخره: ظلام).
.
المغزى من هذا الكلام مو لتفضيل أو لاحتقار بعض الشعوب عن غيرها. كبرنا على جاهلية التفاضل بين الشعوب و الأجناس. المغزى إنو الناس أجناس، منهم ليليين و منهم صباحيين و من بعضنا نستفيد. و بما أن أكثر من 50% من مادتنا الحيوية مائية، فعندنا المرونة الهائلة للتكيف مع الاحتياجات و الضرورات الحياتية للانتقال من طبيعة إلى آخر.
لو ما كان لبعض منا القدرة ليكونوا ليليين، ما سلمنا الليالي. و لو ما كان في بُـنيتنا القابلية للانتقال من الليلية إلى النهارية، ما حضر منا دوامه المدرسية أو المزرعية. و لو عرفت أوجه تشابه عاداتك و تقاليدك مع الوثنيين أو الحنفيين أو اللأغنوستيين، هل ستبقى على إصرارك أن دينك و طقوسك و أسلوب حياتك هي الوحيدة النافعة؟ هل ستبقى على إصرارك أن رأيك و رأي جماعتك هي الرأي الحق المطلق على البشرية أجمع؟
أم ستمسك عن تغيير الآخرين إلى أن تغير شيء من عاداتك الوثنية؟